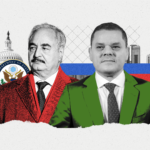لم يتبقَّ سوى عامين على يوم تنصيب الرئيس الأميركي الجديد عام 2021! وثمَّة فرصة كبيرة لأن يكون الرئيس الجديد شخصاً غير الرئيس دونالد ترامب ، وقد يكون من الحزب الديمقراطي. فلتتشجَّعي يا أميركا الديمقراطية.
لكنَّ الوقت قد حان لنسأل: ما مدى أهمية هذا الأمر؟ يتساءل الكاتب الأميركي جيمس تروب، في تقرير نشره بمجلة Foreign Policy الأميركية: ما مقدار ما سنستطيع إصلاحه من الخراب الذي سيكون ترامب قد تسبب فيه حينئذٍ، على الأقل بخصوص علاقة أميركا بالعالم؟ وعلى النقيض، إلى أي مدى سيكون قد غيَّر الواقع القائم سلفاً تغييراً شديد العمق بحيث يُشكِّل واقعاً جديداً صلباً؟
لحسن الحظ، على الأقل من وجهة نظر تنبُّؤية -يقول الكاتب الأميركي- خاضت الولايات المتحدة تجربة مشابهة منذ عقد فقط، حين خلف الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، نظيره الأسبق جورج بوش الابن. يمكننا إذن أن نبدأ تحليلنا الجدلي بأن نسأل عن مقدار ما استطاع أوباما أن يتخلَّص منه من سلوكيات بوش العدوانية الانفرادية المغرورة؟
الرئيس الأميركي الجديد لن يلزمه في الواقع إلا أن يقول: "لقد انتهى الجنون"
إنَّ الهوس الحالي بعلاقة أوباما بما وصفه أكبر مساعديه، بن رودس، بـ"اللطخة" (أي قضية التدخل العسكري في الخارج) قد أخفى ما كان يطمح إليه الرئيس السابق أصلاً، وهو استعادة موقف أميركا الدولي لدعم التعاون بشأن تغيُّر المناخ، والحدِّ من انتشار الأسلحة النووية، وقضايا عالمية مُلحَّة أخرى.
ففي عام أوباما الأول في منصبه، ألقى سلسلة خطابات بجميع أنحاء العالم، في إسطنبول وبراغ والقاهرة، جمع فيها بين لهجة أمل متصاعدة وعرضٍ واقعي لـ "الاحترام المتبادل تجاه المصالح المشتركة".
وتخبرنا بيانات استطلاعات الرأي، فضلاً عن الحشود الهائلة المتحمسة، بأنَّ أوباما نجح في تحقيق هدفه الأول، وهو رفع مكانة أميركا بالعالم، مع أنه تعلَّم أيضاً أنَّ في الدول غير الديمقراطية، بل في كثير من الدول الديمقراطية، لا تُترجَم حماسة المواطن إلى سياسة دولة.
ولا شك في أنَّ الرئيس الأميركي الجديد خليفة دونالد ترامب ، إلَّا لو كان نائبه مايك بنس، سوف يذهب في جولة تطمين مشابهة، ومن المرجَّح أنها سوف تُقابَل بامتنان مستميت مشابه.
ومن ناحيةٍ، سوف ستكون مهمته أسهل، لأنَّ استخفاف ترامب بالحلفاء واستهزاءه بفن الحكم ذاته منحرفٌ جداً وفقاً للمعايير الأميركية التاريخية، لدرجة أنَّ الرئيس القادم لن يلزمه في الواقع إلا أن يقول: "لقد انتهى الجنون".
إضافةً إلى ذلك، تقبع إهانات ترامب الأفدح، حتى الآن، في عالم الخطاب واللفتات وليس الأفعال، لهذا يمكن تصحيحها بسهولة أكبر باستخدام اللغة والسلوك.
وبالتأكيد لن يتردد الرئيس الجديد في أن يقول: "إنَّ أميركا تؤمن بالدبلوماسية وتكرِّم دبلوماسييها". ولن يعامل قائد الولايات المتحدة الجديد روسيا باعتبارها صديقة، ولا ألمانيا باعتبارها عدوَّة. سوف يلتقط العالم أنفاسه، كما فعل عام 2009.
لكن ليس من السهل عليه أن يتخلص من الخراب الذي تسبب فيه ترامب
لكنَّ الرئيس الأميركي الجديد لن يستطيع ببساطةٍ أن يتخلص بالتمنِّي، من الخراب الذي ألحقه ترامب بالمؤسسات، لا سيما الخراب الذي ألحقه بجودة المجاري المائية والهواء. وسوف يتمكن الرئيس القادم من إعادة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا أخرج ترامب الولايات المتحدة منه، لكنَّ إقناع الأوروبيين بأنَّ واشنطن تعتبر أمنهم جزءاً لا يتجزأ من أمنها سيستغرق وقتاً أطول.
إضافةً إلى أنَّ محاولة إصلاح ما أُفسد للمرة الثانية، لا يمكن أن تكون فعَّالة كالأولى. فبعدما عامَل رئيسان جمهوريان الحلفاءَ والمؤسسات التعددية باستخفاف، على الرغم من اعتناق كلٍّ منهما رؤيةً مختلفة جذرياً تجاه العالم، كيف يمكن أن يقنع خليفتهما العالم بأنَّ الولايات المتحدة سوف تعود إلى مبادئ ما بعد انتهاء الحرب، والتي اعتنقتها؟
أي ما الذي سيجعل العواصم الأجنبية تصدِّق أنَّ الولايات المتحدة ملتزمةٌ أمن حلفائها أو نجاعة تلك المؤسسات؟ سيكون من الحكمة أن تقيِّد اليابان وكوريا الجنوبية تحالفهما مع واشنطن بتحسين العلاقات مع بكين، في حين قد تَخلص دول البلطيق إلى أنها لا تملك خياراً سوى أن تُخفِّف من حذرها الحاد تجاه موسكو.
إنَّ مقدار ما سيستطيع الرئيس الأميركي الجديد أن يفعله، أو يلغيه، لن يحدِّده الخراب الذي تسبب فيه ترامب في الخارج، بقدر ما ستحدده التغييرات التي أحدثها بالداخل.
وتجربة أوباما مفيدة في هذا الشأن أيضاً
فقد بالغ أوباما في تقدير التأثير الذي سيخلقه قبوله لدى المواطنين بالخارج في قادتهم، سواءٌ أكان ذلك بشأن الحدِّ من انتشار الأسلحة النووية أم السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. لكنَّ الأهم أنَّ أوباما كان يلزمه أن يكسب الشعب الأميركي في صفِّه لكي يدعمه في اللحظات الفارقة، لكنه لم يفعل ذلك.
وبغض النظر عن آراء أوباما بشأن "اللطخة"، فقد كان يعرف أنَّ لديه دعماً جماهيرياً قليلاً بشأن التدخل القوي في سوريا، أو حتى بليبيا، إذ إنَّ السنوات الـ8 التي ظل جورج دبليو بوش يهلِّل فيها للتدخل في الخارج، قد استنزفت إيمان الشعب الأميركي بقدرة أميركا على تشكيل عالم أفضل. وقد نجح أوباما في تغيير وجهة نظر الأجانب عن الولايات المتحدة، أكثر مما نجح في تغيير وجهة نظر الأميركيين عن أنفسهم.
والعالم مستعد لرفض رؤية ترامب بمجرد رحيله
"وماذا عن فيلسوفنا المبتذل الذي يصبُّ في آذان الأميركيين من حسابه في "تويتر" سيلاً من الشكوك المظلمة، مُصرّاً على أنَّ أقرب حلفائهم يسعون إلى أكل طعامنا، وأنَّ بعض الصفقات التجارية ذات محصلة صفرية، وأنَّ حقوق الإنسان لا يهتم بها سوى الضعفاء الحساسين، وأنَّ الأميركيين يجب أن يعتنوا بأنفسهم في هذا العالم القاسي الذي لا يلين؟"، يقول الكاتب الأميركي، مضيفاً: "يروق لي أن أعتقد أنَّ رؤية الرئيس دونالد ترامب تجاه العالم سوف تُرفَض معه هو نفسه".
إذ يبدو أن المنطق يشير إلى ذلك، فكما أظهرت "أجندة الحرية" الممسوخة الخاصة ببوش للأميركيين فوائد الحذر، ربما تظهر لهم النزعة الانعزالية المزمجرة فوائد التعامل مع الآخر، والاحترام المتبادل للمصالح المشتركة.
من بعض النواحي، يبدو حدوث ذلك مؤكداً. فأيُّ رئيس ديمقراطي سوف يُخبِر أوروبا بأنَّ الولايات المتحدة ما زالت مهتمة بها، وسوف يعامل الرئيسَ الروسيَّ فلاديمير بوتين بصفته عدواً كما هي حقيقته.
وسوف يقلل الرئيس الأميركي الجديد العلاقات مع السعودية إذا استمرت في التصرف بوحشية وتهوُّر، وسوف ينضم مجدداً إلى اتفاقيات باريس بشأن تغيُّر المناخ، وسوف يعيد توكيد أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان في علاقات أميركا الخارجية، وما إلى ذلك. هذه هي المبادئ التي تظل طبيعية.
لكن، لو سحب ترامب القوات الأميركية، ليس فقط من سوريا وأفغانستان، بل من أوروبا وآسيا، فهل سيهلِّل الأميركيون للمرشح الذي يطالب بعودتها؟ هل سيُصر الناخبون على أن تستقبل أميركا حصتها من اللاجئين، وتعود إلى الإنفاق على التطوير والدعم الإنساني؟ ربما لا.
لكن، هناك تحدٍّ آخر مرتبط باتساع الهوة بين النخبة وقاعدة الناخبين
هناك انطباع بأنَّ الفجوة الأميركية التقليدية بين النخبة ذات النزعة الدولية، وقاعدة الناخبين المعنيِّين بما يحدث في الداخل، بدأت تتسع.
وقد بدأت القاعدة الجمهورية في الانصراف عن نشاط السياسة الخارجية حالما صار أوباما رئيساً، وقد استغل ترامب تلك الحالة المزاجية وفاقمها.
وكذلك هناك شعورٌ متزايد بين الديمقراطيين بأنَّ النزعة الدولية القوية لدى وزيرتي الخارجية الأميركيتين السابقتين، مادلين أولبرايت وهيلاري كلينتون، قد عفى عليها الزمن.
قد يجد الشعب مميزات كثيرة تعجبه في مرشح يساري يخبر حلفاء الولايات المتحدة بأنَّ الوقت قد حان لكي يدافعوا عن أنفسهم بأنفسهم، سواءٌ أكانوا يستطيعون ذلك أم لا يستطيعون.
وفي خطابات ومقالات حديثة تعبِّر عن رؤيتهما للسياسة الخارجية، تعهَّد كل من عضو مجلس الشيوخ المستقل بيرني ساندرز، وعضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارن، بمحاربة الفساد والاستبداد والظلم في الخارج والداخل، لكنهما كانا أكثر تحفظاً (لا سيما في حالة ساندرز) بشأن العلاقات مع الحلفاء والقيمة الرادعة للحضور العسكري الأميركي بالخارج.
ربما سيحتاج الرئيس الأميركي الجديد ، لو لم يكن ترامب، أن يبدأ من الصفر، ليشرح للشعب الأميركي لماذا يُعدُّ العالم مهماً، ولماذا توجد فيه فرص كما توجد به تهديدات. هذه بالضبط هي المهمة التي اضطلع بها باراك أوباما في 2009. لكنَّ الحالة السابقة ليست مشجِّعة.