إذا صدَّقت عناوين الأخبار، ربما بدأت تعتقد أنَّ العالم الغربي في حالة سقوط حر. وكما تخبرك عشرات المقالات في المجلات ومقالات الرأي ومنشورات المدونات عن حلف الأطلسي، بُني نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية منذ يوم غزو النورماندي وحتى الأمس، على يد الأميركيين والأوروبيين الذين تشاركوا مُثُل السلام والحرية والديمقراطية. استمرَّ هذا النظام حتى وصل دونالد ترمب إلى سدة الحكم، وأجهز عليه تماماً كما لو كان يضع أساسات كازينو آخر من كازينوهاته.
ربما تكون هذه الأزمة الواضحة هي ما يوحِّد الصحافة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي هذا السياق، تساءلت صحيفة The New York Times الأميركية في يناير/كانون الثاني: "هل انتهت العلاقات العابرة للأطلسي؟". وبعد عدة أسابيع، كتبت تحليلاً أكثر صرامةً بعنوان: "نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية يتعرض للهجوم من القوى التي أنشأته".
وفي ألمانيا، التي تعد قلب التحالف الأوروبي الأميركي، لا صوت يعلو فوق قضية التحالف عند الحديث عن السياسة الخارجية.
وأظهر غلاف حديث لمجلة Der Spiegel الأسبوعية يداً في وضع رفع الإصبع الوسطى، غير أن هذه الإصبع كانت مرسومة بصورة مجسم مصغَّر لترمب. وجادل محرران من الجريدة الألمانية Die Zeit بأنَّ الساسة عليهم أن يقبلوا أنَّ العلاقة انتهت وعليهم المضي قدماً، وقالا إنَّ الكثيرين من الساسة "يرفضون قبول هذا الواقع الجديد، وبدلاً من ذلك يلجؤون إلى جدالات لا طائل منها".
الكاتبة والمحللة في الشؤون الأوروبية السياسية والثقافية مادلين شوارتز نشرت تقريراً مطولاً على صحيفة The Guardian حول معنى وأهداف -وربما نهاية الحلف- مع تغير الأسماء والسياسات المتعاقبة منذ تأسيسه حتى تهديد ترمب الوجودي له.
المؤمنون بالتحالف الأطلسي: الإجهاز عليه ينسف الليبرالية ويهدد تقدم العالم
يُطلق على الفكرة التي تقول إنَّ استقرار العالم وازدهاره محدَّدان في المقام الأول بالشراكة بين الأوروبيين والأميركيين "التعاون الأطلسي" أو "التعاون العابر للأطلسي"، ولدى المهتمين بهذه الفكرة اقتناع أنّ ترمب على وشك الإجهاز عليها.
وبالنسبة للساسة والأساتذة والمحللين الخبراء والصحافيين الذين يرون في الإيمان بهذا التحالف وسام شرف، لا تقتصر تبعات نهاية هذه الشراكة على كونها إشكالاً جيوسياسياً، بل هي أيضاً تهديد لليبرالية ونسفٌ لأي آمال بتحسن الأوضاع السياسية حول العالم.
وفي نظر المؤمنين بأهمية التعاون الأطلسي، تعتمد مُثُل الديمقراطية، وحرية التعبير، ومقاومة الشمولية، وإرساء حكم الدستور، والتجارة الحرة التي تعمل على إثراء جميع الأطراف المشاركة فيها، على قرب العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا. ويعني استمرار التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة، إمكانية استمرار التقدم الغربي.
أميركا قدَّمت الكثير لتشكيل نظام العالم ما بعد الحرب ودعم استقرار أوروبا
في صميم الأزمة الحالية يأتي إرث جهود الولايات المتحدة لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، عبر ثلاث مؤسسات: "بريتون وودز" (النظام المالي المشترك بين أميركا وأوروبا) و "مشروع مارشال" (الذي بموجبه حصلت أوروبا على 100 مليار دولار من أميركا، لإعادة بناء نفسها بعد الحرب العالمية الثانية) و "حلف الناتو" الدفاعي العسكري.
وتعد تلك المؤسسات الأسس التي أقيم عليه ما يُسمَّى بـ "نظام ما بعد الحرب"، وهو برنامج لإحلال الاستقرار في أوروبا، ومنع ظهور أي صور جديدة للشمولية. (يبدو مصطلح "Transatlanticism"، "التعاون عبر الأطلسي" أفضل من "denazification" سياسة اجتثاث النازية).
والحرب الباردة أعطت هذا التحالف مشروعية مبررة
ويرى أنصار التعاون عبر الأطلسي، أنَّ تلك المؤسسات لم تكن مجرد الوسيلة التي أسهمت في تشكيل أوروبا بعد عام 1945، بل إنها تعبيرٌ عن الإمكانات المتاحة أمام القوة الأميركية المثالية.
شكّلت نهاية الحرب الباردة النقطة الأبرز في هذه العلاقة، عندما صارت الفرص التي سبق أن شكَّلت الغرب متاحةً فجأةً أمام الكتلة السوفيتية، لتضفي بذلك مشروعية على الاستراتيجية الداعمة للتعاون عبر الأطلسيّ.
وأصبح هذا التحالف نظرة جديدة على العالم ولموقع أميركا فيه
إذ يمكن أن يكون التعاون الأطلسي وسيلة لنقل ما شهده الغرب إلى الدول الأخرى، وهو ما اقترحه دعاة الأطلسية في السنوات الصعبة التي أعقبت سقوط جدار برلين.
لم تعد الأطلسية مجرد استجابة للأزمات، بل صارت طريقة يُنظر من خلالها إلى العالم، وموقع الولايات المتحدة فيه.
لكن العلاقة بين الحليفين توترت قبل تولي ترمب الحكم بكثير
ولكن هل دمَّر ترمب حقاً العلاقات العابرة للأطلسيّ؟ يمكن أن نرى في عناوين الأخبار منذ ستينات القرن العشرين أنَّ العلاقات تدهورت قبل توليه المنصب بكثير. إذ إنّ عبارات على شاكلة "الأطلسي المتسع" (The Widening Atlantic) و "أطلانتس المفقودة" (Atlantis Lost) ظهرت كعناوينَ لكتبٍ ومقالاتٍ صحفيةٍ على مدى عقود من الزمن.
ومثل زوجين لا تزدهر علاقاتهما إلا عبر انفصالٍ يليه صُلح، لا تزيد الأزمات التي تنزل بفكرة التعاون الأطلسي إلا في التأكيد على أهميته في الأذهان. في عام 1965، كتب هنري كيسنجر -الذي يبرز اسمه بوضوح في تاريخ التعاون العابر للأطلسي- كتاباً بعنوان "الشراكة المضطربة: إعادة تقييم الحلف الأطلسي (The Troubled Partnership: A Reappraisal of the Atlantic Alliance)، حيث يورد في كتابه أنَّ الشراكة بين الولايات المتحدة وأوروبا تمر بحالة توتر شديد، والسبب آنذاك كان الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول. (لم يلق الكتاب رواجاً. وقال كيسنجر مازحاً فيما بعد إنّ المكان الوحيد الذي بيع فيه هي مكتبة وضعته بالخطأ على أرفف كُتب العلاقات).
فلماذا إذاً استمرت فكرة اعتبار العلاقات العابرة للأطلسي محور استقرار العالم؟
- منذ منتصف ستينيات القرن العشرين، تآكلت العديد من الهياكل، التي شكَّلت أساساً للصورة الأصلية من "النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب"، أو اختفت كلياً.
- لم تعد الولايات المتحدة توجه مليارات الدولارات في صورة مساعدات موجَّهة إلى أوروبا، مثلما فعلت قبل عام 1951.
- ولم تعد العملات الدولية مقيَّدة بسياسة نقدية خارجية تُصاغ في ولاية نيوهامبشير الأميركية، مثلما كان الحال قبل عام 1971.
- والبلدان التي شكَّلت من قبل جزءاً من الاتحاد السوفيتي، صارت هي نفسها عضوة بمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ولكن حتى مع تضاؤل حجم التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا، عاش تصور العالم الحر المؤسَّس على أركان عابرة للأطلسي باعتباره فكرة سياسية قوية.
ولا يعود السبب في هذا إلى الشراكة نفسها، التي تبدو متحولةً وغير محددةٍ بوضوح، فهي ليست بناءً أيديولوجياً بقدر ما هي عبارة عن مؤسسة.
فهل يمكن أن يكون الهلع من انهيار التعاون الأطلسي هلعاً يتعلق بهوية الموجودين في سدة الحكم؟
ففي بطن المياه الأطلسية المتعكرة يكمن حنين للقوة الأميركية، وفكرة أنّ حفنةً قليلة من الرجال المثقفين المستنيرين كان بوسعهم ضمان أمن العالم.
"عابر للأطلسي" تعبير مزدهر في ألمانيا تحديداً وليس في أميركا
قبل أن تصل شوارتز إلى ألمانيا قادمةً من نيويورك، في يوليو/تموز الماضي، لم تكن كلمة "عابر للأطلسي" (Transatlantic) جزءاً من مفردات اللغة العامة التي تستخدمها. غير أن التعاون العابر للأطلسي يبدو جلياً في كل مكان ببرلين. بدا جميع الذين قابلتهم في حياتها الجديدة، ضمن عملها كصحافية في الخارج، مبشرِّين بالمشروع الأطلسي.
في وجبة عشاء تناولتها في حيّ شونبيرغ ببرلين، قابلت شابة سافرت إلى برلين للمشاركة في منحة المستشارة الألمانية، وهي برنامج مدته 12 شهراً "يهدف إلى تعزيز الشراكة العابرة للأطلسي"، والتعرف على "القادة المحتملين".
صديق آخر لها أصبح عضواً في المجلس الأميركي للشؤون الألمانية، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تأسست عام 1952 بهدف "تعزيز العلاقات الأميركية الألمانية". بدت لحظات التعريف بالضيوف خلال الحفلات أشبه بفهرس كتاب عن تاريخ أوروبا ما بعد الحرب: زمالة مارشال، زمالة في وسائل الإعلام العابرة للأطلسي، زمالة ماكلوي.
سافرت شوارنز نفسها إلى ألمانيا من خلال أحد هذه البرامج، وتحديداً عبر زمالة من مؤسسة Robert Bosch Stiftung، التي تصف نفسها بأنَّها "مبادرة مميزة عابرة للأطلسي، تقدم فرصةً إلى مجموعة منتقاة من الأميركيين المتفوقين ليستكملوا برنامجاً مهنياً شاملاً متعدد الثقافات في ألمانيا".
مجرد طرحه يعني الخوض في الاستقرار العالمي
استقبل بريدها الإلكتروني أسبوعياً رسائل عن "أهم المطالعات المتعلقة بالتعاون العابر للأطلسي"، ودعوات أسبوعية لمناقشات حول الأزمة الحالية بعناوين مختلفة مثل "حماية التعاون العابر للأطلسي في ظل صعود نجم السياسة الانعزالية"، أو فعاليات للتواصل الشبكي "ندعو خريجي برنامج Fulbright في مجال الإعلام للانضمام إلينا لتبادل آراء ودية حول التطورات الأطلسية الحالية"، أو نقاشات "اضطراب التعاون العابر للأطلسي في ظل حكم ترمب والصدْع في العلاقات مع تركيا".
وفي القاعات الزجاجية المنتشرة داخل بنايات المؤسسة، جَمَعَت هذه الفعاليات العاملين في المؤسسة الفكرية والأميركيين الذين يرتدون بدلاتهم أمام الأطباق التي تحتوي على الشطائر الشهية التي تصاحبها أحياناً زجاجات العصير.
أُتيح متسعٌ من الوقت لتبادل بطاقات التعريف الشخصية. وبغض النظر عن كُنه الموضوع، أضافت كلمة "التعاون العابر للأطلسي" شعوراً بالأهمية المؤسسية، إذ يتحول النقاش بعد ذكر هذه العبارة إلى أمر يتعلق باستقرار العالم بأسره. يظهر في سطر عنوان إحدى رسائل البريد الإلكتروني: "إيران والعلاقة العابرة للأطلسي: هل ثمة فرصة أمام الاتفاق النووي؟" فيما تعهَّد عنوان آخر بمناقشة: "القوميات والشعبويات الجديدة: وجهات نظر عابرة للأطلسي".
ترمب ينتقد ألمانيا خلال إفطار في مقر الناتو
خوضٌ انتشر مؤخراً تحت عناوين "انتهاء الوضع" و "لحظة استفاقة"
صورت هذه الفعاليات نفس الواقع المظلم. فأظهرت العلاقات العابرة للأطلسي في وضع غير مستقر. حرصت المؤسسات الفكرية بصورة خاصة على إثارة هذه النقطة. كتب أحد المحللين في مؤسسة بروكينغز -وهي واحدة من كثير من المؤسسات التي تشكل مصنعاً للأفكار الوسطية المتفانية من أجل المهتمين بالسياسات الخارجية والتي توظف خبراء من على جانبي الأطلسي- ورقةً بحثيةً كبيرة حول "انتهاء الوضع المعتاد" فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: "لم يسبق أن كان الانقسام عبر الأطلسي صارخاً لهذا الحد".
وفي صندوق مارشال الألماني (الذي أُسس في الذكرى الخامسة والعشرين لخطة مارشال بهدف الترويج لمبادئها)، وصلت نفس المحادثة إلى حالة من اليأس.
في سلسلة تسجيلات البودكاست الخاصة بالصندوق، التي تسمى Brussels Sprouts، تحدث المحللون عن الحالة المزاجية في منتدى بروكسل الأخير، وهو المؤتمر السنوي الخاص بهم، ووصفوه بأنَّه كان أشبه بـ "مسيرة جنائزية… إنها لحظة استفاقة في العلاقات العابرة للأطلسي".
ووصف أوروبا وأميركا بأنهما مثل زوجين فشلا في جلسة لإصلاح الزواج
وصف التسجيل الولايات المتحدة وأوروبا بأنهما مثل زوجين فشلا في جلسة لإصلاح الزواج. وقالت كارين دونفريد، وهي مستشارة سياسية سابقة للرئيس باراك أوباما والرئيسة الحالية للمنظمة: "ثمة اهتزاز في الثقة الآن في العلاقات العابرة للأطلسي. نعرف من علاقاتنا الشخصية أنّ تدمير الثقة أسهل بكثير من بنائها".
تقول شوارتز: "أتمنى ألا أبدو أميركية ضيقة الأفق عندما أقول إنَّ التأكيد على "العلاقة" مع الولايات المتحدة جاء بمثابة مفاجأة. كان من الصعب تخيل الذهاب إلى حفل في واشنطن والاستماع إلى الجميع وهم يناقشون النقاط الدقيقة حول السياسة الخارجية الألمانية".
واعتبر أن بين برلين وواشنطن علاقة من طرف واحد
وتضيف: "بدت العلاقة غير متماثلة على نحو مؤثر. هب أنك (من تبادر بالاتصال دائماً)، و (لا تتلقّ من الطرف الآخر أي مقابل على ما أسديت من معروف)، و(تشعر أنك متوتر باستمرار)".
وتشير شوارتز إلى أن العبارات السابقة تشكل 3 إشارات من أصل 8 تعني أنك في علاقة من طرف واحد، وهو ما بدا أنه يصف الشعور في برلين، مثله مثل أي علاقة رومانسية محكوم عليها بالفشل.
لكن الحقيقة أنه لا يوجد تعريف محدد للعلاقات العابرة للأطلسي
كشفت هذه المناقشات عن شيء أكثر دلالة: لا يمكن لأحد أن يُعرّف العلاقات العابرة للأطلسي. لا شك أن منظمة الناتو قائمة، وهي مؤسسة لديها بناياتها وسياساتها وأسلحتها. ولكن عندما يشير الأشخاص إلى التعاون العابر للأطلسي، يبدو كما لو أنَّهم يصفون شيئاً أكبر: إنها ثقافة وليست منظمة. ولكن من جديد ما هو بالضبط؟
والوصف الأقرب أنه نظام عالمي قائم على التعددية والقيم والمجتمعات المفتوحة
مجموعة من الخبراء في مؤسسة فكرية ألمانية "Trotz alledem Amerika" كتبوا الخريف الماضي تقرراً اسمه (بالرغم من كل شيء: أميركا). ذكروا فيه رغم أنّ ترمب أول رئيس أميركي منذ الحرب العالمية الثانية يشكك تشكيكاً جوهرياً في النظام الدولي الليبرالي، ظلت علاقة ألمانيا بالولايات المتحدة حجر الأساس لسياستها الخارجية.
دشنت المجموعة موقعاً إلكترونياً مع صورة كبيرة للمحيط الساكن الذي لا تظهر له نهاية. لكنها لم تستطع تعريف العلاقات العابرة للأطلسي. قالت المؤسسة الفكرية في بيان لها: "النظام العالمي الليبرالي بأُسسه القائمة على التعددية، وقواعده وقيمه العالمية، وأسواقه ومجتمعاته المفتوحة يواجه خطراً".
ولكن إذا كانت الأعراف والقيم المشتركة تشكل أساس النظام العالمي الليبرالي، فما هي تلك الأعراف والقيم؟
تعد الولايات المتحدة وألمانيا، كمثال لبلدين على جانبي الأطلسي- بلدان النظام الديمقراطي البرلماني التمثيلي، هذا صحيح. ولا يحتاج الأمر الكثير من البحث لنرى بوضوح أوجه الاختلاف في الأعراف والقيم المتعلقة بأنظمتهما السياسية:
- قوانين استخدام الأسلحة النارية صارمة في ألمانيا، لكنها ليست كذلك في الولايات المتحدة.
- خطاب التحريض على الكراهية مسموح في الولايات المتحدة ولكنه غير مسموح في ألمانيا.
- لدى ألمانيا نظام رعاية اجتماعية قوي بخلاف الحال في الولايات المتحدة.
- النظام السياسي في ألمانيا ما بعد الحرب أُسس لتجنب تركيز السلطة بينما يسمح نظيره الأميركي حسبما يبدو باستيلاء رشيق عليها.
- يتسامح الألمان مع العُري في الأماكن العامة، فيما لا يسمح الأميركيون بذلك. وما إلى ذلك من اختلافات أخرى.
أجل، تقدّر الدولتان "الحرية" و "الديمقراطية"، لكن النظامين الحاكمين فيهما يبدوان أكثر تواؤماً عندما يُنظر إليهما من عدسة مجردة، أو على جانبي محيط.
لم يكن هناك أوروبا موحدة أساساً للدخول معها في شراكة
لم يكن للتعاون الأطلسي أبداً معنىً بالغ الرسوخ والثبات. أحد أسباب ذلك أنَّ الولايات المتحدة وأوروبا لم ينظر كل منهما إلى الآخر باعتباره حليفاً سياسياً طبيعياً على الدوام. ففي أغلب أوقات التاريخ الأميركي، لم يكن هناك من الأساس "أوروبا" موحدة للدخول في شراكة معها.
نشأت الفكرة المتعلقة بوجود تحالف سياسي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قبيل الحرب العالمية الأولى، وكان تحالفاً مناهضاً لزئير التهديدات المصاحبة للشيوعية والقوة الألمانية المتنامية.
وكانت ألمانيا خارج حسابات "المجتمع الأطلسي" الجديد
كان الصحافي المتخصص بالسياسة والتر ليبمان أحد الرموز التي فعلت الكثير لنشر فكرة الالتزامات الأوروبية تجاه الولايات المتحدة. أسس ليبمان مجلة New Republic، التي كانت مجلة نافذة في واشنطن آنذاك وتتمتع بعلاقات مع الحكومة.
ووصف ليبمان في عدد صادر عام 1917 – ومرة أخرى في كتابه الصادر عام 1943 "السياسة الخارجية الأميركية: درع الجمهورية" (US Foreign Policy: Shield of the Republic) – أهمية وجود "مجتمع أطلسي" تكون ألمانيا عدوه الرئيسي.
كانت بريطانيا، وإسبانيا، والبرتغال، وهولندا، وفرنسا، وبلجيكا، والدنمارك، والنرويج "مشاركين مشاركة حيوية في نظام الأمن الذي ننتمي إليه" ومن ثمَّ فإنّ هذه الدول تعد شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة. وقد اتسعت معه القائمة لاحقاً لتضم السويد، واليونان، وإيطاليا، وسويسرا. واستثنى من هذه القائمة دول أوروبا الشرقية التي حررتها آنذاك ألمانيا من أيدي السوفيت. إذ لا يمكن التعويل على التزامها.
ردد مفكرون آخرون أفكار ليبمان. ففي الكتاب الأعلى مبيعاً في عام 1939 "الاتحاد الآن" (Union Now)، دعا الصحفي كلارنس شترايت لفكرة اتحاد يتكون من 15 دولة قومية تمتد من الولايات المتحدة إلى نيوزيلندا.
تأسس التحالف بين القوى العالمية العظمى: أميركا وبريطانيا وفرنسا
استندت الوثائق المؤسسة للتعاون الأطلسي- الميثاق الأطلسي، وهو عبارة عن إيضاح مجمل لأهداف الحلفاء وسياستهم، وقع عليه فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل؛ ومعاهدة شمال الأطلسي، التي شكلت أساس منظمة الناتو، التي وُقِّعت عام 1949- إلى أعمال ليبمان وشترايت لتصور تحالف أمني بين بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وعندما اجتمع القادة الأميركيون، والبريطانيون، والفرنسيون في لحظات مميزة لصياغة هذه الوثائق، وضعوا أيضاً نظاماً نقدياً، وهو نظام بريتون وودز، الذي صِيغ لتنظيم العلاقات النقدية بين الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا الغربية، واليابان؛ ووسيلة لإعادة إعمار أوروبا تمثلت في خطة مارشال. وهذا النظام هو الذي يشكل أساس "النظام العالمي الليبرالي لمرحلة ما بعد الحرب".
مهمته التقارب وحماية الحرية والديمقراطية والثقافة المشتركة
لا شك أنَّ المؤسسات تبدو أكثر جاذبية إذا كانت نسخة طوباوية وليست مجرد طريقة لكبح جماح أشكال جديدة من الاستبداد. (حتى البيروقراطيون يفضِّلون أن يروا أنفسهم أصحاب رؤى وليسوا صائغي قواعد).
شكّل التعاون الأطلسي الأساس لمهمة أمنية تضطلع بها منظمة الناتو، لكنه كان أيضاً معنياً بوصف ثقافة محددة: التقارب المفترض بين الولايات المتحدة وأوروبا. كان من المفترض أن تلتزم الولايات المتحدة وأوروبا بتاريخهما ومبادئهما المشتركة.
فقد أعلنت البلاد التي وقعت على الاتفاقية الأصلية لمنظمة الناتو: "إن أطراف هذه الميثاق… عازمون على حماية الحرية، والحضارة والتراث المشترك لشعوبها، مؤسَّسة على مبادئ الديمقراطية، والحرية الفردية، وحكم القانون".
فما هي الثقافة المشتركة، ومن الذي كان يتشارك فيها؟
كان الهدف العام للناتو "إخراج الروس، وإبقاء الأميركيين، وإهانة الألمان"، حسب الكلمات الساخرة التي يقال إنها جاءت على لسان هاستينغز إسماي، كبير مساعدي تشرشل وأول أمين عام لحلف الناتو.
امتلكت خطة مارشال، التي شكلت حجر الأساس في هيكل التعاون الأطلسي، مكوناً أيديولوجياً قوياً معنياً بنشر قيم محددة وذلك لأنها -إذا أردنا التحديد- لم تكن مشتركة.
ففي الفيديوهات والإعلانات الملصقة والقاعات الدراسية والمؤسسات التي تروج للرأسمالية على حساب الأسواق الخاضعة لسيطرة الحكومة، كانت المساعي ترمي إلى نشر ما زعمت أنه القيمة الأميركية المتعلقة بالعمل الجاد على حساب على مسألة التهديد الروسي. وفي المقابل، حصلت أوروبا على المال والحماية والسلام.
يلوح في الأفق إرث هذه المؤسسات بدرجة كبيرة نظراً إلى أنها حققت إنجازات حقيقية، وأحرزت نقاطاً بارزة في الدبلوماسية الأميركية، والتعاون، والمثالية. لكن هذه المؤسسات لم تكن ثابتة، ناهيك عن الخرافات الشائعة عن النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب التي تصفها بأنها كانت قلاعاً للاستقرار.
روَّج كينيدي لهذا الحلف القوي قبل أن يتم اغتياله
يشير المؤرخون الأميركيون إلى أن بدايات الستينيات من القرن العشرين كانت ذروة التحالف الأطلسي، حين دعا جون كينيدي إلى "إعلان الترابط" مع أوروبا، في الرابع من يوليو/تموز 1962.
جلس كينيدي في قاعة الاستقلال بمدينة فيلادلفيا الأميركية، حيث جرى التوقيع على أول دستور أميركي، ودعا لـ "شراكة أطلسية ثابتة". عندما اغتيل كينيدي في العام التالي "اختفى المجتمع الأطلسي في غمضة عين"، حسبما كتب المؤرخ فرانك كوستيغليولا.
ولكن عندما تعافت أوروبا لم تعد المصلحة الأميركية تدير هذا الحلف
وفي غضون ذلك، عندما صارت أوروبا أقوى وتغيرت الحاجة إلى المساعدة الأميركية، تغيرت معها أيضاً المؤسسات التي تتوسط التحالف الأطلسي. إذ إن المجتمع الاقتصادي الأوروبي عام 1957، وبعدها تأسيس الاتحاد الأوروبي، أعطى مصداقية إلى النقاشات التي تشير إلى أنّ التعاون الأطلسي لا يمكن أن يكون مدفوعاً بالمصالح الأميركية وحدها.
دعا جان موني، أحد مؤسسي الجماعة الاقتصادية الأوروبية، إلى نهج "سخيف" للتعاون العابر للأطلسي، يجري بموجبه تقدير المصالح الأوروبية والأميركية تقديراً متساوياً. ولم تلق مساعي موني أي نجاح.
فانسحبت فرنسا وانهار نظام بريتون المالي ولم يعد الحلف واضح المعالم
انسحب ديغول ببلاده فرنسا من هيكل القيادة العسكرية للناتو عام 1966، ودافع عن الاستقلال الفرنسي النووي. وانهار نظام بريتون وودز المالي في السبعينيات، ليضع نهاية لإحدى مؤسسات ما بعد الحرب التي سعت لغرس نظام أطلسي حول العالم.
ولمّا بدأت أركان التعاون الأطلسي في الترنح، صار من الصعب تحديد ماهية التعاون الأطلسي على وجه الحقيقة. لم تكن إحدى الأوراق البحثية التي أصدرتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي عام 1962 واثقة بالضبط مما يعنيه هذا التعاون؛ إذ كتبت: "تُستخدم أحياناً للإشارة إلى مبدأ الناتو، إضافة إلى الأبعاد الاقتصادية، والثقافية، وربما السياسية، للشراكة القائمة.
وفي أحيان أخرى، تشير إلى تطلعات طويلة المدى، وإن لم تكن معلنة رسمياً، لتأسيس مجتمع اقتصادي وسياسي أقرب، قد تصحبه تبعات دستورية بين البلاد الواقعة على (شواطئ) المحيط الأطلسي.
تستخدم العبارة أيضاً مع ما يتعلق بجهود تعزيز العلاقات بين الحلفاء الغربيين عن طريق البرامج قصيرة الأجل، ولا سيما في مجالات التعليم والثقافة. بل إنَّ الرقعة الجغرافية للمجتمع الأطلسي ذاته غير محددة المعالم، إذ يتحدث البعض عن ضم أميركا اللاتينية، ويتحدث آخرون عن قصرها على أوروبا الغربية وأميركا الشمالية".
حاول هنري كسينجر إنقاذه في ظل تلاشي ذاكرة الحرب العالمية
في عام 1973، أطلق هنري كيسنجر، وهو نفسه لاجئ عبر الأطلسي، جولة "عام أوروبا"؛ كي يحاول إنقاذ العلاقة باسم الاحتواء، لمنع تزايد نمو الاتحاد السوفيتي.
تحدث كيسنجر باعتباره مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي ريتشادر نيكسون، وسأل ما إذا كان من الممكن ازدهار المجتمع الأطلسي في ظل تلاشي الذاكرة المتعلقة بالحرب العالمية الثانية.
وقال إنه "مع تلاشي الانقسامات الصارمة للعقدين الماضيين، تبرز تأكيدات جديدة على الهوية الوطنية والمنافسة الوطنية". وذكر أنَّ الأميركيين ينبغي عليهم الاستمرار في دعم الوحدة الأوروبية. وأضاف في كلماته: "إذا سمحنا بضمور الشراكة الأطلسية فسوف نخسر فرصتنا التاريخية لتحقيق إنجاز أعظم".
واقترح ضم اليابان رغم تململ الأوروبيين من "صيغته" الأميركية
لم يلقَ حديثه آذاناً صاغية. واستغل القادة الأوروبيون سطراً يذكر "الدور الإقليمي" للقارة والدور الأميركي "العالمي". وقال كيسنجر لاحقاً: "لعله من عدم الحصافة أن نجعل الحقيقة جلية، لكن الانتقاد الأوروبي للصياغة مثَّل مزيجاً من النفاق والخداع".
عندما زار المستشار الألماني، فيلي براندت، أميركا بعد أشهر من ذلك، اشتكى كيسنجر من أن نيكسون بدا مشتَّتاً، وصار براندت كما لو أنه غير مهتم. غير أنه حتى مع هذه المحاولة لإعادة تأكيد المجتمع الأطلسي، كان من الصعب التبين تماماً من الشيء الذي استند إليه هذا المجتمع: القيم؟ إذا كان الأمر هكذا، فأي قيم؟ هل هذا الشيء هو الأرض؟ فإذا كان هكذا، فأين هي تلك الأرض؟ تركزت إحدى نقاط كيسنجر على التشجيع على إدخال اليابان إلى المجتمع الأطلسي.
السمة المستمرة للتعاون الأطلسي أنه كان على وشك الانهيار على مدار 50 عاماً
إذا كان لدى التعاون الأطلسي سمةٌ مستقرةٌ ومتسقةٌ، فهي أنّ هذا التعاون كان على وشك الانهيار في الأعوام الـ50 الماضية؛ إذ إن المناشدات المتعلقة بالعلاقة الأطلسية ارتبطت بالمخاوف من التراجع والخطر اللذين يحيطان بها.
وبرز ذلك في كتبٍ ومقالاتٍ على شاكلة "حدود التعاون الأطلسي" (The Limits of Atlanticism)، و"نهاية الأطلسي" (The End of Atlanticism)، و"نهاية الغرب: الأزمة والتغير في النظام الأطلسي" (The End of West?: Crisis and Change in the Atlantic Order)، كما بيَّن المؤرخان فاليري أوبورج وجايلز سكوت سميث.
كانت العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا عبارة عن أخذ وردٍّ بين بغضٍ وحبٍ متبرم. أغضب جورج بوش الأب حلفاءه الأوروبيين بالحرب في الخليج. وأظهر كلينتون التزامه الأطلسي لحلف الناتو عبر غاراته الجوية بالبوسنة، في حين غزا جورج دبليو بوش العراق وكاد يمزق الحلف.
بلد عربي كاد يفكك هذا التحالف
قبل أن تتشكل الأزمة الأخيرة في صورة دونالد ترمب، شكَّلت حرب العراق اللحظة الأخيرة التي سارع خلالها المعلقون إلى الإعلان عن أن العلاقات عبر الأطلسي تواجه "نقطة انهيار".
أصدرت مؤسسة بروكينغز ورقة بحثية تتحدث عن "مشكلة خطيرة جداً" و"نقطة حرجة". وجاء في هذه الورقة البحثية: "حتى أفضل الزيجات أحياناً تنتهي بالطلاق".
اتفق خبراء السياسة على أن جزءاً من اللوم ينبغي أن يُوجَّه إلى "رئيس أميركي فظٍّ يتحرك تحركات أحادية". وأشارت ورقة بروكينغز إلى أن "اللغة المتعجرفة والعنيفة والتدين العميق في رسالته الرئيسية، جعلت الأوروبيين ينتابهم شعور عميق بأنهم أجانب وأغراب".
انتاب القلقُ الأوروبيين والأميركيين على جانبي الأطلسي من أن الشراكة كانت في طور التفكك. (وحتى بالولايات المتحدة، لم تكن هناك إجابة، في الغالب، عن السؤال المزعج: من كان جزءاً من المجتمع الأطلسي؟ وفي النهاية، لم تكن الاستجابات للحرب استناداً إلى أسس دقيقة للخطوط الجغرافية. برغم أنَّ أغلب الأوروبيين اعترضوا على غزو العراق، كانت المملكة المتحدة وبولندا حليفين رئيسيَّين للولايات المتحدة).
وحتى أوباما خطب كثيراً عن الأطلسي لكنه كان يركز في مكان آخر
أدى انتخاب باراك أوباما إلى تهدئة الوضع. فقد عرف كيف يعزف على وتر استدعاء الحنين الأطلسي عند الضرورة. وقال في أول خطاب من الخطابات الثلاثة التي كان سيلقيها أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين (ترمز إلى انقسام المدينة خلال الحرب البادرة ثم استعادة وحدتها): "انظروا إلى برلين. التقى عزم شعبٍ بسخاء خطة مارشال وخلق معجزة ألمانية، حيث أدى الانتصار على الاستبداد إلى صعود الناتو، وهو أعظم تحالف مُشكّل على الإطلاق للدفاع عن أمننا المشترك".
لا يعني ذلك أن سياسة أوباما نفسها كانت ذات طابع أطلسي مميز؛ إذ إنّ إحدى النقاط المركزية لسياسته كانت قائمة على "محور آسيا".
ورغم كل شيء.. تبجُّح ترمب ليس جديداً وهناك قوى تحارب الانفصال

ولم يكن ردُّ فعل أوروبا على ترمب مثالاً استثنائياً للتاريخ الدبلوماسي؛ بل الرد المعتاد على نوع محدد من الطابع الاستثنائي لأميركا.
لا شك في أن رؤى ترمب الأحادية، وفظاظته و"تبجُّحه"، جميعها أمورٌ تحمل خطورة وعدائية، لكنها ليست أموراً جديدة كلياً.
إذا استمر التعاون الأطلسي في إبقاء قبضته القوية على تصورات السياسة الخارجية، فلا يرجع السبب في ذلك إلى رؤساء البلاد الذين يتصافحون مع رؤساء الوزراء.
إذ تزدهر العلاقة في الشبكات العديدة التي تحتشد من أجل الإبقاء على وجودها ضد أي تراجع محتمل.
وكتب المؤرخ ديفيد إلوود: "بحلول عام 1965، كان من الممكن وضع قائمة بـ10 مجموعات رئيسية خاصة عملت -أو كانت لا تزال تعمل- للترويج للفكرة الأطلسية"، ومن ضمنها جمعية حلف شمال الأطلسي، ومجموعة بيلدربيرغ، والمعهد الأطلسي في باريس.
أغلقت بعض هذه المنظمات أبوابها منذ وقت طويل، لكن العديد منها لا يزال ينشر أوراقاً بحثية ويرعى نشر الأبحاث.
نخبة أطلسية "شبه مقدسة" وُلدت من هذا التعاون
وحسبما ذكر أستاذ التاريخ في هارفارد، البروفيسور تشارلز ماير، فإن التعاون الأطلسي جلب معه "نخبة أطلسية جديدة".
وأضاف تشارلز: "الرحلات عبر الأطلسي، ومنتديات السياسة الخارجية المشتركة، وشبكة من الجمعيات ذات الروابط المشتركة القائمة على تنظيم النقاشات والاحترام المتبادل- خلقت (جميعها) في الواقع مجموعةً حاكمةً عابرة للحدود الوطنية… حقق أبرز أعضاء النخبة الأطلسية لأنفسهم مكانة شبه مقدسة: مارشال، وماكلوي، ولافيت، وبول سباك، وموني، وآخرون من (الرجال ذوي الحصافة)، الذين أوصوا بالجهود المشتركة والتعاون".
في هذه الأنواع من الشبكات لا تزال الشراكة عبر الأطلسي مزدهرة: أي من خلال عمليات التبادل، وفعاليات وحفلات الاستقبال، وبرامج القيادة، والمِنح الدراسية والزمالات.
ولمّا كانت حالة من انعكاس الذات -مُعرَّفة تعريفاً جزئياً بأنها حالة من الحفاظ على الذات- تدفع هذه المؤسسات إلى الواجهة فكرةً تنظر إلى العلاقات الأوروبية-الأميركية على أنها محورٌ مركزيٌ في القوة العالمية.
وفي السياقات اللغوية التي تستخدمها المؤسسات الفكرية وصناديق التمويل، لا يرمز تعبير "أطلسي" إلى مجموعة حقيقية من القيم بقدر ما هو تكوين فارغ يمكن تعبئته بأي معنى يريده منظِّموه: الديمقراطية الليبرالية، أو الشراكة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، أو الاستمرار البسيط للهياكل التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية ولم يُعَد تعريفها منذ ذلك الحين.
تغيَّر العالم نعم، ولكن لم يتغير موقع القوة
تقول شوارتز في ختام تقريرها: "من الصعب ألا ندرك ولو قدراً ضئيلاً من الحنين إلى الماضي في اللغة التي تستخدمها هذه المؤسسات: لقد صغنا خطة مارشال ونفذناها؛ فثق بنا".
ولعل هذا هو السبب الذي حافظ على ثبات وِجهة النظر الأطلسية في ظل عالمٍ متغير. لم تعد السياسة مدفوعة بالمصالح "الأطلسية" وحدها. صارت قوى المحيط الهادئ أقوى بكثير مما كانت عليه في الأربعينيات من القرن العشرين. ولكن، ما هي قرارات السياسة العالمية المهمة التي يمكن اتخاذها اليوم دون النظر إلى الصين والهند؟
بيد أن ثمة استمراراً للتركيز على الشبكات القديمة؛ لأنه عندما لا تُعرَّف الأفكار مطلقاً وعندما لا يُعاد تقييم المواقف فلن يبقى سوى مجرد شبكات؛ إذ إن حلم التعاون الأطلسي يحمل في جزء منه فكرةً، مفادها أنه في ظل تغيُّر العالم، لم يتغير موقع القوة. ويمكن للأميركيين والأوروبيين أن يستمروا على المنوال نفسه الذي ساروا عليه من قبل. فالدبلوماسية والقيادة أمران لا يحتاجان إلى تغيير؛ لأنهما نجحا في الماضي.
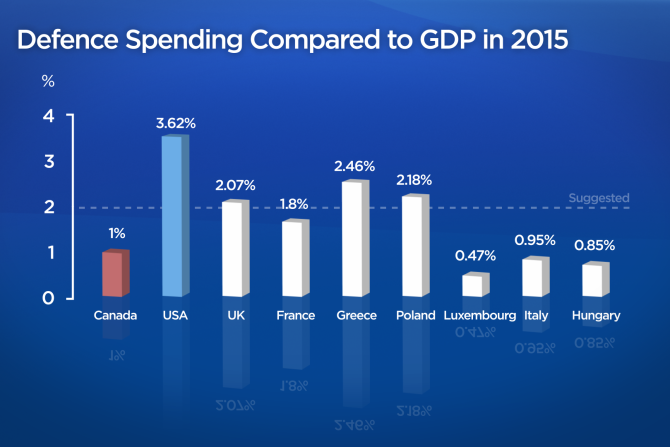
وألمانيا ما زالت تدعو لتواصل المجتمعات على طرفي الأطلسي
في مؤتمرٍ أميركي-ألماني استضافته جمعية Atlantik Bruecke (تعني "الجسر الأطلسي") والمجلس الأميركي للشؤون الألمانية، عُقد في ربيع 2017، ألقى وزير الخارجية الألماني آنذاك، زيغمار غابرييل، خطاباً يدافع عن إرث خطة مارشال.
أخبر غابرييل المشاركين في المؤتمر بأنَّ مستقبل التعاون الأطلسي في أيديهم. وقال: "يجب علينا أن نشمر عن سواعدنا ونذهب إلى العمل على جانبي الأطلسي".
وقد تعرض في حديثه، غير ساخر على ما يبدو، إلى تزايد "العزلة" داخل المجتمعات الأوروبية والأميركية. أضاف غابرييل: "يجب علينا أن نعمل على تواصل هذه الأجزاء من مجتمعاتنا بعضها مع بعض؛ تلك التي لا تجتمع في صالة المسافر الدائم بمطار فرانكفورت، أو في مطار واشنطن دالاس الدولي".
مم كانت تتألف رؤية غابرييل عن التعاون الأطلسي؟ من المؤكد أنها كانت تتألف من القيم والأعراف. فقد ذكر الثلاثي الغامض والمحبب والمفيد لدعاة الأطلسية: "القيم الغربية الحقيقية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية وحكم القانون".
وذلك استجابة لسياسة "القوة الناعمة"، التي تلجأ إلى حرب الإقناع بدلاً من العنف
تبدو مخلّفات خطة مارشال جليةً في كل مكان بألمانيا؛ إذ إن السفر حول البلاد، ولا سيما في نصفها الغربي، قد يجعل المرء يظن أنها آخر بؤرة استعمارية أميركية؛ إذ يوجد شوارع تحمل اسم كينيدي في كل مدينة، ويوجد "مركز ألماني-أميركي" بكل شارع يحمل اسم كينيدي. تمتلئ ألمانيا الغربية بالقاعات الحكومية ومراكز المؤتمرات التي شُيِّدت بتمويل من خطة مارشال والولايات المتحدة: فهي غير مرتفعة، وعملية، ونظيفة. وفي حين يقترح صنّاع السياسة الأميركيون "حروباً" على المخدرات، والجريمة، والفقر، يقترح صناع السياسة الألمان "خطط مارشال".
على مدى العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، جلبت هذه المكتبات والمراكز الثقافية الكتبَ والأفلام والثقافة الأميركية إلى ألمانيا؛ وكانت بمثابة جندي مطيع فيما أطلق عليه جوزيف ناي، الأستاذ في هارفارد، "القوة الناعمة"، التي تلجأ إلى خوض حرب الإقناع بالتأثير الثقافي بدلاً من استخدام القوَّة الغاشمة.
فالألمان قلِقون من أميركا التي وُعدوا بها مقارنة بالتي يرونها الآن
لم تعد هذه المؤسسات تخدم ذلك الهدف. والآن لست في حاجة إلى الذهاب إلى المكتبة الأميركية التذكارية في برلين لمعرفة الكتب الجديدة التي نُشرت بالولايات المتحدة.
وبدلاً من هذا، صارت هذه المؤسسات تخدم هدفاً آخر، حيث يذهب الألمان القلقون للتعبير عن مخاوفهم مما يحدث في الولايات المتحدة، أي إنها مكان لعقد لقاء مفتوح، ولكن من أجل بلد آخر.
يمكن أن يتساءل الأوروبيون في هذه الأماكن عن كيفية تحوُّل أميركا التي وُعدوا بها إلى أميركا التي يرونها.
وتروي شوارتز كيف رأت خلال العام الماضي (2017)، داخل المعهد الألماني للعلاقات الثقافية الخارجية في شتوتغارت، حشداً قلقاً يسأل القنصل الأميركي إذا ما كان ترمب يكره الألمان حقاً.
وتُردَّد أسئلة على غرار "هل يريد الرئيس حقاً التخلي عن ألمانيا باعتبارها حليفة لبلاده؟ ألم يستطع أن يتصل بأنجيلا ميركل مثلما فعل أوباما؟ لماذا أخبر القادةَ الأوروبيين الآخرين في بروكسل بأن الألمان كانوا (سيئين؛ بل سيئين جداً) ونشر تغريدة غاضبة عن العجز التجاري؟". فنصحهم القنصل بألا يقرأوا ما يُنشر على "تويتر".
لكن الحلف سيبقى كما كان: انتهاز سياسي سيُمنح وقاراً وتبجيلاً بوزن التاريخ
وبغض النظر عن التغيرات السريعة التي تطرأ على العالم، يستطيع التعاون الأطلسي أن يصمد، ليس باعتباره انعكاساً للسياسات كما هي تماماً؛ بل باعتباره وصفة مضمرة لمن ينبغي أن يضطلع بدور القيادة.
في هذا الخريف، سوف يسيء ترمب إلى حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، وسوف يدعو الساسة الألمان إلى "نظام عالمي جديد"، وسوف تهدئ ميركل من حدَّة هذه المحاولات. وإذا ذهبت إلى المركز الألماني-الأميركي في شتوتغارت، وهو أحد المعاهد المعنيَّة بالتعاون العابر للأطلسي في المدينة، يمكنك حضور فعالية عبر أطلسية تسمى "Transatlantic ArtConneXion"، وهي فعالية من أجل "الأميركيين والألمان النشطين في المشهد الفني"، ويمكنك مقابلة Baltimore Beauties، وهي "مجموعة دولية متعددة اللغات مهتمة بتنجيد الألحفة يدوياً، والحياكة، والكروشيه".
ويمكنك أيضاً حضور إحدى فعاليات مجموعة الدراسة المسماة Empire: "وهي عبارة عن استكشاف شهري للمصالح والأعباء العالمية للولايات المتحدة".
وأيَّا كان ما سيحدث في الأزمة الأخيرة، فسوف يستمر التعاون الأطلسي، ممثَّلاً في مجموعة غامضة من المُثُل التي تعود بنا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. من المعلوم أن غموضها يحمل فائدة عظيمة: إنها انتهازية سياسية تُمنح وقاراً وتبجيلاً بوزن التاريخ.

